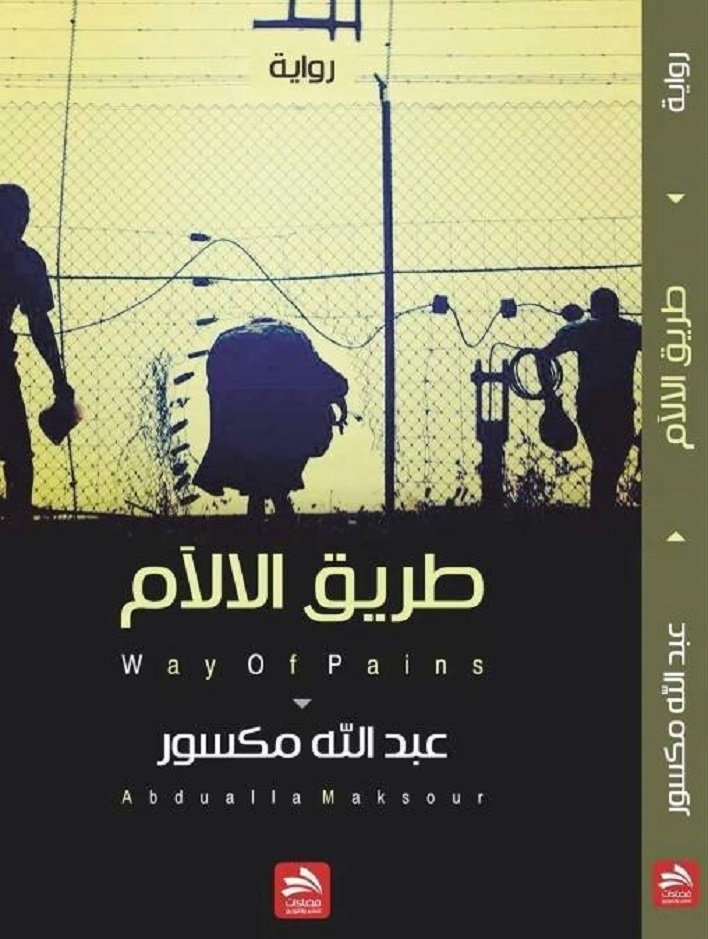[تنشر هذه المادة ضمن ملف خاص حول التناول السردي للحرب والعنف في سوريا. للإطلاع على جميع مواد الملف اضغط/ي هنا]
الروائي السوري عبدالله مكسور
أمام سيل المعلومات التي تغمرُ الواقع من كل أطرافه نظن أننا بتنا نعرف العالم، واكتشفنا المدن المختبئة خلف غبار التاريخ أو العمارة المدنيّة وحديثًا مختفيةً خلف غبار القذائف التي باتت تجتاح مدننا التي احتوت الذاكرة الأولى، هكذا تبدأ الخطوة الأولى نحو شهية الكتابة للتخلص من الأوهام التي تشوب تعامل وسائل الإعلام مع الحدث المأساوي في سوريا مثالًا، الحدث الذي جاء مفاجئًا لوسائل الإعلام كان مفاجئًا أيضًا بذات الدرجة للمشتغل بالأدب وعليه كان اللجوء إلى تخيُّل اللحظة في واقعٍ متحرك أمر غير ممكن، كان لزامًا من هنا الكتابة عن سوريا الثورة بتجريد الدوافع الأولى والإنحياز للإنسان والذاكرة معًا على حد سواء، نقل الحياة اليومية بأفراحها وأحزانها وأمواتها وشخوصها ومعطوبيها وحالاتها لم يكن أمرًا يسيرًا، ذلك أنه يحمل من المغامرة ما يكفي للتفكير بإعادة تركيب البيئات الثقافية والإجتماعية والنفسية والثقافية التي كانت قائمة، فصار كل شيء مطروحًا على طاولة الكتابة، وعندما أقول كل شيء فإني أبدأ بالعقد الإجتماعي الهش أصلًا وصولًا إلى العقد الديني.
في الحالة السورية اليوم لا بد من طرح السؤال التالي: لمَن يكتب الروائي في حالة الدمار الكلي؟، ولمن يُطلِق سهام كلماتِه؟، وهل عليه أن يتخذ موقفًا واضحًا قبل الخوض في الكتابة من النقطة صفر، المسافة صفر هنا تعني الإلتصاق بالحدث والتلوث بدمائه في كل اتجاه؟، الكتابة في هذه الحالة لم تعد لأجل الذات والعبارة الأكثر شيوعًا "أكتب لنفسي"، إنها كتابةٌ لأجل قضية أيًّا كان اصطفاف الروائي فيها لكن عليه أن يكون جنديًا حقيقيًا يمتلك من المكنة والمقومات ما يُمكنه من خوض الجولات حتى النهاية.
القصة هنا ليست عملًا توثيقيًّا إنها كتابة فصول التاريخ المعاصر الذي يقع على مقربة منا، كما نراه بأعيننا من زواياه المتعددة، ولوضوح أكثر سأضرب مثالًا من القرن التاسع عشر حيث عبَرَ الرحالةُ العرب والأوربيون البحر المتوسط والطرق الوعرة بإتجاهين متعاكسين وتركوا لنا صورة أدبية موازية للتاريخ المكتوب، نجد فيها ما غفل التاريخ عن تدوينه، فالتاريخ يقوم على تدوين العموميات بتفاصيل قليلة أما الأدب فيقوم على التفاصيل التي تُشكِّل في نهاية المطاف اللوحة الكليَّة العامة، إنها مثل لعبة تركيب القطع الصغيرة الخاصة بالأطفال - كما أراها في الأدب الذي قدَّمته عن سوريا في السنوات الأخيرة - تبدأ من حالة الذات المذابة كليًا مع الحدث وتتفرع منها إلى العام، من الجزء إلى الكل ومن الخاص إلى العام فتكون اللوحة في نهايتها مثل لوحات الفنان الهولندي الشهير "بيتر بروغل" حيث لا يكتشف الناظر تفاصيل اللوحة إلا إذا وقف على مسافة كافية من زواياها ليراها بوضوح تام، تلك الجزيئيات التي تتحد مع بعضها في بُعدِ الناظر والمتلقي عن الحدث تجعله يكتشف أشياء عديدة لن يتسنَّ لهُ رؤيتها إذا كان قريبًا، وفي ذات السياق فإن الصورة التي تطغى على الأدب الذي يتناول المأساة اليوم هي بشكل أو بآخر صورةُ الهوية التي يتم سفكُها واللعب بها، هي العلاقة التي يمارسها الكاتب مع اللغة في الرواية خصوصًا في الحالة التي تتناول حدثًا يقع الآن، حيث تغيبُ خطوط الذاتية والفردانية في الهم الجمعي ويذوب الهم الجمعي في الذات الواحدة، فضحايا ما يحدث يحمل كل منهم رواية في صدره ليحكيها، التقيتُ بالمئات منهم، قصصهم تتنوع في أرض الميدان وعلى أطرافها، في مخيمات النزوح وعلى بوابات الوطن، على الشواطئ الغريبة وفي قلب القوارب المتهالكة، في مراكز العبور بين بلدان عديدة، في مخيمات اللجوء المؤقت، في البدايات المتلعثمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نحن هنا أمام حالة مرعبة من الحكَّائين الذين كانوا أبطال رواياتهم، وهذه ميزةُ هذا الأدب الذي تناول بجرأة ما يحدث دون تجميل.
الروائي هو الشخص الأضعف في لعبة التضاد التي تسود حقيقة الواقع في البلدان المنهارة، فحين تشتعل المُدن في رحلة الحريق لن توقفها كلماته، فقط ستلذعه بحروق غير قابلة للعلاج في الوقت القريب، إنها الكتابة من المسافة صفر في مواجهة الرصاص الخارق والبرميل المتفجر والحزام الناسف والشعارات المُدمِّرة، تفاصيل الحالة الروائية هنا في إعتقادي لا تهم من حيث الشكل سواء جاءت الرواية بصيغة تقليدية أو على شكل تحقيق صحفي مُوسَّع "كما أشتغلها أنا"، المهم هو أن تصل إلى القارئ برسائلها التي أرادها الكاتب من خلال لغة بسيطة غير إنفعالية، الإنحياز إلى طرف دون آخر في النص ليس وليدًا عن حالة إنفعالية، إنه نتيجة قناعات ومشاهدات عديدة تولَّدت لدى الكاتب قبل البدء في معركة الكتابة لإيجاد نص أدبي يتحدث عن الحالة المعاصرة.
الروائي ليس قائدًا للتغيير وليس مؤثرًا به، في الحالة السورية قد يلعب دور الراصد لتحولات هذا التغيير فهو لا يملك القدرة والقوة على تغيير مساره إذا انحرف، وهذا ليس لضعف منه بل لأن أصوات الرصاص والراجمات أعلى من صوت الكلمات وأوزان الشعر، وما ينتج عن المخاض العسير الذي تعيشه البلاد لا يشفع للعمل السيء فاقد القيمة الأدبية بمعناها الفني، فقدسيّة الحدث في التناول لا تعفي الكاتب من ميزان الجودة، والقول بأن على الأديب الإنتظار حتى انتهاء الحدث هو حالة من العجز فالحدث وُلِدَ مُكتَمِلًا، والسؤال أين ستصل به مراحل الإكتمال القادم، هذا ما على الروائي إلى جانب آخرين الإجابة عليه.
وعلى هذا فإن قيمة الكتابة الأدبيّة التي تنتج عن سوريا اليوم هي في أن أبطال الحكاية ما يزالون على قيد الحياة وهم الذين سيحكمون على جودة العمل الأدبي وصدقيَّته في حال وجدوا أنفسهم فيه، فالناس تبحث في كل العصور عن صورتها في الأدب.
*************
عبد الله مكسور في سطور:
صحفي وروائي سوري من مواليد مدينة حماه 1983، يحمل إجازة في الآداب والعلوم الإنسانية، وماجستير مهني في الإعلام والعلاقات العامة. وهو يقيم حاليا في بلجيكا.
بدأ الإشتغال في الصحافة المرئية منذ العام 2006، وتنقل بين العديد من القنوات الفضائية العربية، الإخبارية والإجتماعية والإقتصادية.
رَأَس تحرير العديد من المجلات الدورية ويكتب بشكل دائم في صحيفة "العرب" اللندنية.
تعتبر روايته "أيام في بابا عمرو" من أولى الروايات التي خاضت تفاصيل الثورة السورية، حيث تأخذنا في رحلة سرد ورقية عن أحداث حقيقية من خلال بطل الرواية، وهو صحافي شاب يعود إلى بلاده لإنجاز مجموعة من الأفلام الوثائقية عن الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في منتصف آذار/ مارس 2011، وتحولت إلى حرب تحرق الأخضر واليابس على الأرض السورية لغاية يومنا هذا. ويدخل "مكسور" سراديب الأحداث في الباب الثامن لمدينة حمص السورية، من خلال رصد للهجمات الشرسة التي عانى منها حي "بابا عمرو" باستخدام كافة الأسلحة الثقيلة من الطائرات الحربية والدبابات والمدافع.
وفي "عائد إلى حلب" يتابع "مكسور" سرديته للحرب في سورية، وقد تركزت في الرواية الأولى (أيام في بابا عمرو) في حمص وريف حماة، بينما تتركز في هذه الرواية في حلب وريف حماة أيضًا، عدا عن الحدود السورية التركية. وفي الروايتين ترافق الكاميرا الراوي الصحافي الذي ما عادت تعنيه الصور التي التقطها في الجزء الأول من حي بابا عمرو وسواه. وفي هذا العمل يستمر الراوي السرد الدرامي للأحداث عبر العديد من الأشخاص الذين يختلفون مع بعضهم بعضًا في كثير من الأشياء و يتفقون على ضرورة القتال حتى آخر رصاصة .
في صفحات الرواية هناك صوت واضح للرصاص الذي ينطلق من كل الجبهات غير مكترث بالوطن الذي وصل حدّ الهاوية إن لم نعلن وقوعه فيها .
وفي روايته الأخيرة "طريق الآلام"، والتي تعد خاتمة الثلاثية الروائية "أيام في بابا عمرو" و"عائد إلى حلب، والتي تحكي (الثلاثية) عن مرارة التغريبة السورية معجونة بمرارة الفواجع. وتحكي "طريق الآلام" تجرية هجرة غير شرعية لشاب سوري هو الراوي الوحيد والمنخرط بالأحداث وأحد أبطالها وليس العالِم بكل شيء، إنما الشاهد على كل شيء والإنسان الذي يتحسّر على وطن منتهك، هو الشاهد على الموت السوري الموزع بين قوات النظام والجماعات المسلحة.
صدَرَ له خمس روايات:
"شتات الروح"، دار فضاءات للنشر، عمّان 2011
"الطريق إلى غوانتانامو"، دار فضاءات للنشر، عمّان 2011
"أيام في بابا عمرو"، دار فضاءات للنشر، عمّان 2012.
"عائد إلى حلب"، دار فضاءات للنشر، عمّان 2013.
"طريق الآلام"، دار فضاءات للنشر، عمّان 2015.
وله قيد الطباعة:
"نوهادرا"، (رواية)، تصدر في 2016.
"أبناء البحر"، (رواية).